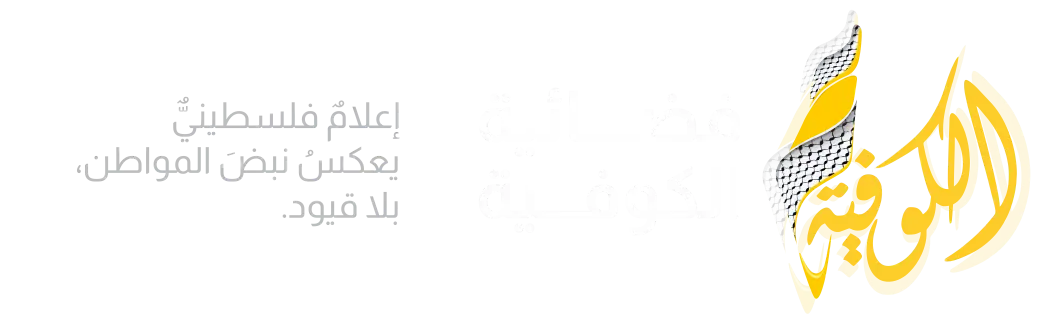ريم بنا من مرايا الروح إلى مرايا الذاكرة

عدلي صادق
ريم بنا من مرايا الروح إلى مرايا الذاكرة
أطفأ الموت أسطع القناديل في منزل فراس بَنّا، الفلسطيني المسيحي النصراوي الجميل، القابض هو وحرمه زهيرة، على جمر الهوية الفلسطينية، في وجه الرياح الصهيونية العاتية. فمن بين مصابيح ذلك البيت البديع، ليس أسطع من الإبنة "ريم" التي شابهت أباها وأمها في روح الوطنية الرفيعة، لكنها تفوقت عليهما، بصوتها الملائكي الذي أبرم مع التراث الشعبي الفلسطيني، بغنائه وأهازيجه وتهاليله وأثوابه المطرزة، وترانيم كنائسه وأصوت المآذن، عقداً مُلزماً، على ضمان حياة أبدية لثقافة الفلسطينيين البسطاء السعداء، في حقولهم وبساتين بلادهم وجماليات لباس فتياتهم الشعبي و"قنابيز" الكبار، وأفراحهم وأحزانهم!
ريم بَنّا، الفنانة المتمردة على قوس الهزائم، الطالعة من الأرض ومن أرض الأرض، لكي تزرع في قُبّعة الحاخام، قلقاً وجودياً؛ اختارت الموسيقى كمنظومة سلاح متعدد الفوهات والأعيرة، على أن تكون أولى وظائف هذه المنظومة، في تجربتها، جَعْل فلسطين حاضرة ومستمرة في السياق الاجتماعي والحضاري التاريخي. فمثلما في فلسطين، الطفل الصغير البريء، والشيخ والسيدة المُجَربان، والشاب الكادح الذي أشقاه العمل في الأرض وفي ميناء حيفا، والمتعلم والأمي، والرزين واللعوب؛ فإن منظومة الموسيقي، في أداء ريم، التزمت أن تحاكي كل ألوان الطيف في وطنها، بالآلات النفخية والوترية والكهربائية وبآلات القَرْع.. الناي والبوق والكُنترباس. العود والقيثارة والكمان والأورغ، والطبلة والدَف. فعندما يقتضى المشهد الذي تتخيله ريم، اصطفافاً اجتماعياً راشداً في أوقات الجِد، ترى موسيقاها هرمونية دقيقة التنظيم، وإن كان المشهد الذي رسمته بكلمات أشعارها الغنائية البسيطة، يماثل فوضانا الفلسطينية في حالات الانفعال غبطةً أو حزناً، تصبح موسيقى ريم، طليقة كالفوضى غير المقيدة، ممزوجة بما يسمى الإيقاعات العضوية التي يزيدها اشتعالاً تصفيق المنفعلين وأصواتهم. وعندما يتعلق الأمر، بترانيم كنيستها المسيحية، فلا بد للترانيم المستعارة في موسيقاها، أن تحافظ على طابعها الوطني، المضاد للصهيونية ومشروعها!
في حياة ريم، ومن مكانها الجغرافي المُعلّق، كقلادة، على صدر فلسطين التاريخية أو خارطتها، كانت هناك تجربة أدبية وفنية استثنائية، ذات مواصفات غير مسبوقة، لا تتقبلها سوى ذائقة بشر من فضاءات ثلاثة. إما الفضاء الوطني الفلسطيني، أو فضاء الأحرار في كل الدنيا، من عشاق فلسطين ومساندي قضيتها، أو فضاء طلاب العدالة والحرية في أوطانهم!
هي إذاً، موسيقى لا يتقبلها اللاهون والمُبتذلون والطغاة والأوغاد، ولا يتقبلها بالطبع الإمبرياليون ومحتلو بلادنا.
ظلت زهيرة الصباغ، أم ريم، تكتب الشعر وتطاوع ميلها الى التصوير الفوتوغرافي، لكن ما تراكم من أشعار الأم وأعمالها، لم يلب طموح ريم التي اتسمت بشجاعة لافتة، حتى في مواجهة الموت. فعندما نَشرت ريم صورتها حليقة الرأس، قالت لجمهورها: أريدكم أن تتقبلوني كما أنا لأنني في مرحلة علاج كيميائي جديد.. إن هذا العلاج أفقدني شَعري.. لكنّه لم يُفقدني ابتسامتي.. ولا روحي المرحة المُفعمة بالتفاؤل والحب والحلم..". وعندما اقترب منها الموت، كتبت قبل أقل من أسبوعين على صفحتها:" بالأمس .. كنت أحاول تخفيف وطأة هذه المعاناة القاسية على أولادي .. فكان علي أن أخترع سيناريو ..فقلت لا تخافوا .. هذا الجسد كقميص رَثّ .. لا يدوم ..حين أخلعه ..سأهرب خلسة من بين الورد المُسجّى في الصندوق .. وأترك الجنازة "وخراريف العزاء" وأحاديث الطبخ وأوجاع المفاصل والزكام ... ومراقبة الأخريات الداخلات .. والروائح المحتقنة ... وسأجري كغزالة إلى بيتي ... سأطهو وجبة عشاء طيبة .. سأرتب البيت وأشعل الشموع ... وانتظر عودتكم في الشرفة كالعادة .. أجلس مع فنجان الميرامية ..أرقب مرج ابن عامر .. وأقول .. إن هذه الحياة جميلة .. أما الموت فإنه كالتاريخ .. فصل مزيّف!
هذا ما يمكن قوله، لمناسبة الظهور الأخير لهذه الفنانة الفلسطينية النصراوية، على مرايا الروح، وانتقالها الى حيث تنتصب مرايا الذاكرة والوجدان. فلا موجب للتكرار الرتيب، لفقرات من تاريخ حياتها وأعمالها. طوبى لها، ولتُبلل قبرها قطرات الندى!